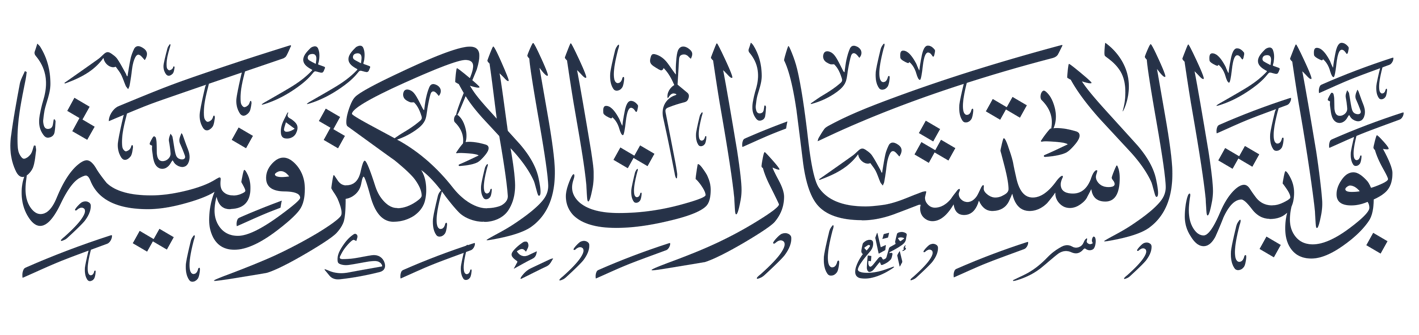الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 253
253 - رقم الاستشارة : 669
12/01/2025
 253
253 لاحظت أن بعضا من علماء الفيزياء يرون أن الإلحاد قام على أسس علمية وأن هذه الأسس هي ما تدعو إلى الإلحاد فهل الإلحاد العلمي حقيقة وله ما يدعمه من العلم والمعرفة أم مسألة الإلحاد العلمي وهم كبير يروج له البعض لتبرير الكفر؟
الرؤية الإيمانية تشير إلى أن الخشية من الله سبحانه تتولد في نفوس العلماء الحقيقيين؛ لذا حث الإسلام على طلب العلم، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وطالب الناس بالتفكر في الكون فالحياة في أبسط صورها معجزة عظيمة تستدعي التوقف الطويل والتأمل من العقول المؤمنة، تأخذ مما تراه في الكون مادة لليقين بالخالق سبحانه وتعالى.
وقد نبّه القرآن الكريم إلى الغرور الذي يخلقه العلم في النفوس، وهو غرور يقود إلى الإلحاد والكفر والتيه، ولذلك جاءت الآيات لتلفت الانتباه إلى ذلك المأزق، فقال تعالى في سورة الجاثية: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ فالحواس التي وهبها الله للإنسان تعطلت عن الوصول إلى الغاية من العلم وتحقيق الاعتبار، واستخدام العلم طريقًا إلى الخالق.
ولذا فإن أحد المسببات الكبرى للإلحاد هو الإيمان بالعلم فقط، ولذلك يسعى الإلحاد لإسباغ العلم على إنكاره وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالإلحاد العلمي، وهو ليس ظاهرة حديثة، ولكنه قديم، ظهر من الحضارات القديمة؛ ففي الحضارة المصرية القديمة ظهر اسم "تحوت" وحسب المعتقد الفرعوني كان إله الطب والعلم والحساب، وفي الحضارة اليونانية القديمة عُرف "أسكليبيوس" بأنه إله الطب، وفي الخبرة الإسلامية ظهرت طائفة تسمى "السُمنية"، وكانت تقول بأزلية العالم، وإنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكرت البعث بعد الموت، أي أنها أنكرت الوحي كسبيل للمعرفة، وآمنت إيمانا كاملا بالمادة، وأن الحواس وليس الوحي هي الطريق الوحيد للعلم والمعرفة.
ومن ثم فإن فتنة العلم وغروره أمر قديم للغاية، وليس أمرًا مستحدثًا مع الفيزياء الحديثة، أو تنامي العلوم والمعارف، ولكن الإلحاد الحديث يعيد تكرار مقولات الإلحاد القديم لأنه لا يملك غيرها، وربما هذا ما تبنه إليه "فيرنر هايزنبيرج" عندما قال: "إن أول جرعة من كأس العلوم الطبيعية سوف تحوّلك إلى ملحد، ولكن في قاع الكأس، ستجد الله في انتظارك".
والمعروف أن "هايزنبيرج" حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، وصاحب أحد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة، وهو مبدأ عدم التأكد أو عدم اليقين أو مبدأ الشك معناه "أن علم الفيزياء لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن تكون لديه تنبؤات إحصائية فقط، إننا لا نستطيع أن نتنبأ بحركة الأشياء مستقبلاً بدقة متناهية، بل تظل هناك نسبة ولو صغيرة من عدم التأكد، ومعنى هذا المبدأ أنه مهما كان الإحكام وتطوير وسائلنا في القياس فلن يمكننا ذلك من التوصل إلى معرفة كاملة للطبيعة من حولنا".
وبالتالي حسب هذا العالم الفذ، فالعلم مهما وصلت درجة دقته وقوة أدوات قياسه فإن ما يقدمه هو احتمال من احتمالات أخرى، وإن هناك دومًا هامشًا للخطأ لأن العالم مهما بلغت درجة رسوخه في العلم لن يحيط بالظاهرة أو المادة من جميع جوانبها؛ ولذا عاد "هايزنبيرج" للتأكيد على الفكرة بقوله: "إن عدم استطاعتنا معرفة المستقبل لا تنبع من عدم معرفتنا بالحاضر، وإنما بسبب عدم استطاعتنا معرفة الحاضر".
كانت هذه النظرية مُقلقة للعلماء في وقتها لدرجة أن عالماً كبيراً مثل أينشتاين قد رفضها أول الأمر، ومع ذلك لم يجد العلماء أمامهم إلا قبول هذه النظرية.
وقد تحول العلم إلى فتنة إلحادية مع الحداثة، وظهر ما يسمى بـ"العلموية" Scientism التي تحولت إلى نوع من الأصولية الدينية، ورأت أن العلم قادر على الإحاطة بكل الحقائق الكونية، وأن البشر ليسوا في حاجة إلى مصدر آخر للمعرفة، وقد وصف الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه جارودي هذه النزعة بقوله: "إن تلك الأصولية العلمية آمنت بأن العلم يمكنه حل المسائل كلها، وأن ما لا يمكن للعلم أن يقيسه ويختبره ويتوقعه هو شيء غير موجود".
وسعى عدد من العلماء الغربيين لنقض تلك النزعة الغرورية للعلم، والتي تدفع حتمًا إلى الإلحاد، ومن هؤلاء عالم الفيزياء الأمريكي "فريمان جون دايسون" صاحب عدة نظريات في فيزياء الكم والفلك والذي قال: "العلم ليس عبارة عن مجموعة من الحقائق. إنه استكشاف مستمر للألغاز". أما الشاعر الإلماني "جوته" فوجه نقدًا فلسفيًّا علميًّا للفيزياء، فقال: "إن أعظم مصيبة في الفيزياء الحديثة هي أن تجاربها قد تم فصلها عن الإنسان؛ إذ ترفض الفيزياء الاعتراف بالطبيعة في أي شيء لا يتم عرضه بأدوات اصطناعية، بل وتستخدم هذا كمقياس لإنجازاتها!!".
كانت الفكرة القديمة بأن الأرض تستقر في مركز الكون، وآمن بتلك الفكرة غالبية البشر لقرون حتى أذكى العقول، وكان لديهم الحجج القوية لاثبات فكرتهم، بل والتندر واتهام من يخالفهم بالجهل وعدم العلم وضحالة الرأي والعقل، والآن يعتقد العلماء أن الأرض تتحرك، وهذا الأمر يدعو للتساؤل: لماذا حصل الاعتقاد القديم؟ ولماذا وجد الأساس لقبوله؟ ولماذا أخذ صفة العلمية رغم أن الواقع لم يتغير في الحالتين؟!
العلماء في السابق افترضوا أن الحقيقة هي ما يمكن ملاحظته مباشرة وهو ما يتفق مع الحس العام، أما المفكرون المعاصرون فيفترضون أن الواقع مخبأ، وأن حواسنا لا تستطيع الوصول إليه مباشرة؛ فالحواس تخدع وتُخدع، أيضًا، وهنا تصبح الحقيقة افتراضات، وكما يقول الفيزيائي الأمريكي ستيفن واينبرغ "كلما بدا الكون مفهوما أكثر بدا عديم الجدوى".
ولخص هذه الأزمة الفيلسوف المسلم سيد نصر في كتابه "الإنسان والطبيعة: الأزمة الروحية في الإنسان الحديث" بالقول: "لقد استخدم مخترعو المحرك البخاري في القرن التاسع عشر نظرية فيزيائية تعتبر اليوم زائفة علميًّا، والواقع أن أغلب المخترعين حتى وقت قريب كانوا في الغالب يجهلون علم عصرهم وطبقوا نظريات ثبت زيفها، وعلاوة على ذلك، فحتى اليوم يمكن لنظرية فيزيائية أو كيميائية أن تتغير، بينما يظل تطبيقها دون مساس، وبالتالي فإن نجاح العلوم التطبيقية ليس سببًا لقبول عصمة النظريات العلمية".