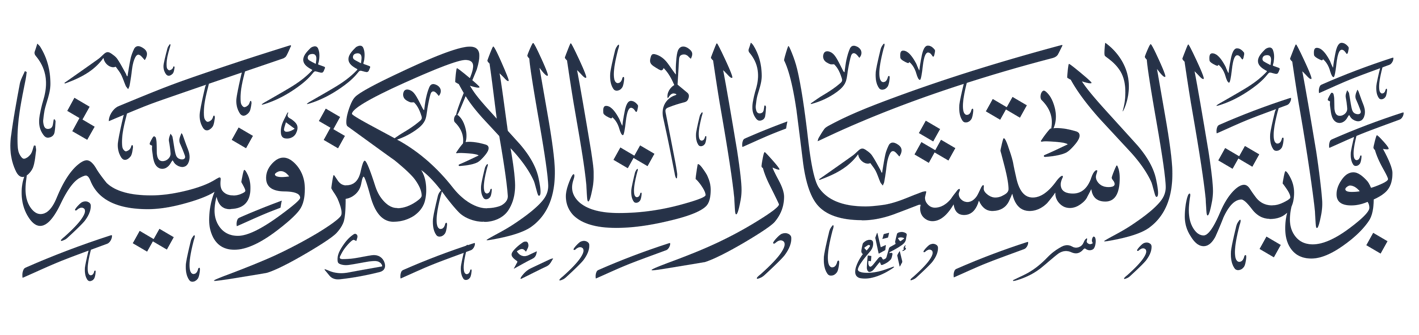الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 439
439 - رقم الاستشارة : 612
07/01/2025
 439
439 أوضاع الأقليات في العالم الإسلامي والمنطقة العربية صعبة ومؤسفة، والسؤال: هل ساهم الفكر الإسلامي الحديث بطروحات لتحسين أوضاع الأقليات وحمايتها، ومنع التعدي عليها، أم أن ذلك الفكر لم يناقش تلك القضية؟
يظن البعض أن قضايا الأقليات بطن رخو في الفكر والفقه الإسلامي قديمه وحديثه، يمكن من خلالها تشويه الإسلام، أو تقييد حركته السياسية؛ لذا لا تثور مثل هذه القضايا إلا في لحظات التحول الكبيرة، التي تتطلب من المسلمين تكثيفًا لجهودهم في النهضة والتنمية والإصلاح. وربما تكشف الحالة السورية بعد نجاح ثورتها المباركة، بعد قرابة العقد والنصف من التضحيات الكبيرة التي زادت على خمسمائة ألف ضحية، وملايين المهجرين، أن الذي كان يقف وراء كل هذا الاضطهاد هو حكم الأقلية وليس الأغلبية، ولم يطرح سؤال ديكتاتورية الأقلية حينها، ومن ثم يجب ألا يفصل إثارة قضايا الأقليات عن الغرض السياسي والسياق السياسي.
ومع هذا فإن معرفة عطاء الفكر الإسلامي المعاصر في قضايا الأقليات وغير المسلمين أمر مهم للغاية، فالمعرفة بتلك الأفكار المتقدمة التي طرحها العلماء والمفكرون المسلمون تشكل حصانة فكرية ضد أي محاولة للشغب على الإسلام أو إعاقة مشاريعه الإصلاحية.
"ليس في تاريخنا في موضوع الأقليات ما يشين".. حقيقة قالها المفكر والقاضي الراحل "طارق البشري"، وكانت تلك نقطة البداية، التي ساهمت في قوة الأفكار التي طرحها الفكر الإسلامي المعاصر في مجال الأقليات، فهؤلاء انطلقوا من الإسلام عقيدة وشريعة لطرح رؤاهم، ولم يتجاوز هؤلاء الإسلام وأحكامه، وهو ما يحسب لهم فكريًّا ودينيًّا ووطنيًّا.
وقد دارت اجتهادات الفقهاء والمفكرين المسلمين المعاصرين حول عدة موضوعات رئيسية، منها: إعادة تحرير مفهوم أهل الذمة، وخلصت الغالبية من تلك الاجتهادات أن المفهوم أصبح مفهومًا تاريخيًّا منذ وقوع غالبية الأقطار الإسلامية تحت نير الاستعمار الغربي، ثم سقوط الوحدة الجامعة للمسلمين المتمثلة في الخلافة الإسلامية؛ ولذا سعى الكثير من هؤلاء إلى خلق تناغم بين المفهوم وبين الشكل العالمي للدولة الحديثة التي أخذ في الظهور عقب معاهدة وستفاليا عام 1648م، والتي كانت نقطة البداية لتأسيس مفهوم المواطنة في الفكر الحديث عالميا.
ويلاحظ أن الكثير ممن قدم اجتهادات في ملف الأقليات جمع بين الفقه الشرعي ودراسة القانون الوضعي، مثل: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، واستطاع هؤلاء الأفذاذ استخلاص آراء الفقهاء وصياغتها في شكل قانوني يمكن للعقل الحديث استيعابه.
ومن الأمثلة الناصعة لتلك الأفكار، برنامج الحزب الوطني، وكان من أوائل الأحزاب التي تنشأ في الشرق، وقد كتب برنامجه الإمام محمد عبده في ديسمبر 1881، ومما جاء فيه: "الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب، وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إليها لأنه لا يُنظر لاختلاف المعتقدات، ويعلم أن الجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية".
ثم جاء الشيخ عبد الوهاب خلاف، وكان من كبار علماء الأزهر المجتهدين، وقدم إضافة كبيرة من خلال كتابه "السياسة الشرعية"، وقال الشيخ خلاف بوضوح في هذا الكتاب النفيس: "الإسلام جعل لغير المسلمين الحرية التامة في أن يقيموا شعائر دينهم في كنائسهم ومعابدهم وجعل لهم أن يتبعوا أحكام دينهم في معاملتهم وأحوالهم الشخصية".
وهناك في العراق، حيث التنوع المذهبي والعرقي والديني، حصل الفقيه والعلامة العراقي "عبد الكريم زيدان" على رسالته للدكتوراة عام 1962، بعنوان "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام"، وفيها تجلية للموقف الفقهي الناصع في قضايا الأقليات، يقول الشيخ زيدان في مقدمته: "وقد التزمت في بحثي أن أكون وراء الشريعة دائمًا، استخلص أحكامها كما هي، فلا أطوعها لما تهوى نفسي، ولا أحملها ما لا تحتمل، ولا أُقولها ما لم تقل"، وفي هذه الكتاب المهم اجتهادات فقهية مقارنة، وقد رجح فيها "جواز الاستحداث والبناء للمعابد".
وبعيدا في الهند وباكستان، حيث التنوع أشد وأكثر في كل شيء نجد العلامة الكبير "أبو الأعلى المودودي" الذي أصدر كتابه "حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية" في منتصف القرن الماضي، وأكد أن في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة، والرأي والتفكير، والاجتماع، والاحتفال، وأشار المودودي إلى مجموعة من الحقوق، منها: حفظ النفس، والمساواة أمام القانون الجنائي، والمساواة أمام القانون المدني، ومما قاله: "يتساوى المسلم وغيره في الحقوق المدنية، ويفرض على الذمي ما يفرض على المسلم من الحدود والقيود في القانون المدني".
أما الشيخ يوسف القرضاوي فمنذ السبعينيات من القرن الماضي واجتهاداته واضحة في هذا الشأن، خاصة ابتعاده عن استخدام مصطلح أهل الذمة فيذكر في كتابه "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" الذي أصدره عام 1977 بأنه لم يفضل استخدام مصطلح أهل الذمة، ويقول: "ولكني لم أختر لكتابي عنوان "أهل الذمة" كما فعل الإمام أبو الأعلى المودودي رحمه الله، لما أصبحت كلمة "أهل الذمَة" غير مقبولة عند إخواننا من مواطنينا من أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا، وهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بلساننا".
أما المفكر والقانوني الدكتور محمد سليم العوا، فخطا خطوة متقدمة، فأعاد تعريف الأقلية لتصبح أقلية سياسية وليس عرقية أو دينية أو مذهبية في ظل الدولة الحديثة، وقال: "إن الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه قد قرر أن الكثرة الدينية وحدها لا توجب حقًّا، والقلة الدينية وحدها لا تمنع من اقتضاء حق".. و"أن الفقه السياسي قرر أن الانتماء للجماعة السياسية لا يجوز على أساس الدين، وادعاء اقتصار ممارسة العمل السياسي على أهل دين معين في دولة متعددة الأديان لا تسنده الشريعة، ولا عليه من الفقه دليل، وهو لا يحقق أي مصلحة مشروعة، والقاعدة أن كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، بل هو يجلب المفاسد، والقاعدة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
أما الدكتور محمد عمارة فله حديث مستفيض عن حقوق الأقليات في المجتمع المسلم الحديث، ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة وهي أن الحقوق الممنوحة لتلك الأقليات ليست منحًا من حاكم ما، أو نتاجًا لفترة تاريخية معينة، ولكنها حقوق تحميها الشريعة الإسلامية، يقول عمارة: "جعل الإسلام لهذه الحقوق قداسة دينية سماوية، يستحيل قيام الدين إلا بها، وليست منحة تتغير بتغير الحاكم، أو اختلاف الزمان والمكان" وأشار إلى أربعة حقوق أساسية:
* حق المساواة بمفهومها الواسع ليشمل المساواة في تكافؤ الفرص، وانتفاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
* حق العدل الشامل: ويشمل الحياة المادية والاجتماعية، والثروات والأموال، بضابط الشريعة .
* احترام عقيدتهم ودور عبادتهم: أوجب الإسلام احترام دور عبادتهم، ومساعدتهم في ترميمها إن احتاجوا إلى ذلك، ولا يكون ذلك دَينا عليهم، بل هو إعانة لهم على مصلحة دينهم.
* حق الحرية: والحرية بمفهومها الواسع تشمل الحرية الاجتماعية والاقتصادية في ممارسة العمل والمهن، مع الحرية الدينية.