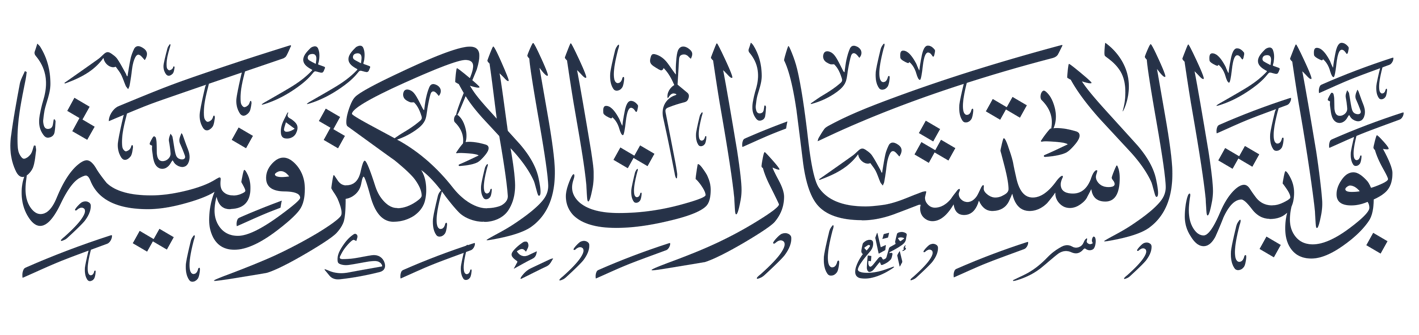الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 269
269 - رقم الاستشارة : 994
16/02/2025
 269
269
أسمع كثيرًا عن مصطلح أو مفهوم الحداثة.. فما هي الحداثة؟ ومتى نشأت وعلاقتها بالإنسان في زمننا الحالي؟
الحداثة من المفاهيم المعقدة المتشابكة، التي توصف بها عدة فترات في تاريخ الغرب، ومن ثم فإن كل حداثة مرتبطة بسياقها التاريخي، لكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات كبرى:
الأولى: في القرن الخامس عشر الميلادي، ونشأت مع الخروج الأوروبي من القرون الوسطى إلى بدايات التنوير، وتتميز بثلاثة تحولات كبرى، أولها: الخروج الأوروبي إلى العالم الجديد مع حركة الكشوف الجغرافية وتحول الثقل التجاري من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي، وثانيها: الخروج على سلطة الكنيسة من خلال الإصلاح الديني وظهور المذهب البروتستانتي الذي كان ثورة على الكهنوت وسطوة الكنيسة وتسلطها، وثالثها: حركة التنوير التي يمكن التأريخ لها باختراع "غوتنبرغ" للمطبعة عام 1440م.
الثانية: تطلق الحداثة -كذلك- على الفترة من 1870 حتى 1910 والتي ارتبطت بما يسمى بالثورة الصناعية الثانية، والتي نما فيها التصنيع السريع والواسع وظهور الدولة القومية والأيديولوجيات والاكتشافات والنظريات العلمية.
الثالثة: وهي الحداثة المعاصرة والتي بدأت من 1910 حتى 1960 وارتبطت بالثورة التكنولوجية والفردانية وانتشار وسائل الإعلام وزيادة المدن وسكانها.
وقد لدت الحداثة مفتقرة إلى الإيمان واليقين، ومُخاصمة لكل مقدس إلا عقلها وذاتها، ومُبشرة بإنسان جديدة لا ينظر إلى السماء ولا يهتدي بأنوارها، وغايته أن يُخضع كل شيء لسيطرته وسطوته.
أهم مرتكزات الحداثة:
- العودة للتراث الإغريقي اليوناني: أعاد مفكرو عصر التنوير إعادة اكتشاف هويتهم بالرجوع للتراث اليوناني والإغريقي، ذلك التراث الوثني، واستلهموا منه مفاهيمهم الكلية الجديدة، فكان هناك استبعاد للخالق سبحانه وتعالى وتغيير محل التقديس، فنجد المفكر الفرنسي "ديكارت" أطلق مقولته الشهيرة "أنا أفكر أنا موجود"، وهو ما يعني تقديس الذات الإنسانية، واعتمادها على نفسها وحواسها في اكتشاف الوجود دون الحاجة إلى الوحي والغيب، وكانت تلك هي البداية للمادية المفرطة التي تميزت بها الحداثة.
- الاكتفاء بالعقل: كانت العقلانية أو الاكتفاء بالعقل دون الوحي أو الحاجة إلى السماء والإيمان من المرتكزات الكبرى في نشأة الحداثة، والعقل يعتمد على الحواس في تحصيل معرفته، فليس هناك محل أو مكان للغيب كسبيل لتحصيل المعرفة، وهذه النزعة أخذت في التزايد، تحت شعار براق هو "نزع السحر عن العالم"، وهي عبارة أطلقها الشاعر الألماني "فريدريش شيلر" وطورها عالم الاجتماع الشهير "ماكس فيبر"، ومضمونها عدم الإيمان بالغيب في تحصيل المعرفة أو فهم الوجود، وإحلال العقل محل الغيب، وسعت العقلانية إلى أن تكون نسقًا معرفيًّا كاملاً ومتماسكًا وكبديل عن الغيب.
تحمل الحداثة تصورًا كونيًّا يحل العلم فيه محل الله، وقد لخّصها المفكر المسلم النمساوي محمد أسد في مقولته الشهيرة: "الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة وصراحة، ولكن ليس في نظامها الفكري موضع لله، ولا تعرف له فائدة، ولا تشعر بحاجة إليه".
ويمكن رصد بعض تأثيرات الحداثة على الإنسان المعاصر في عدة أمور، منها:
نسبية الأخلاق: فتنحية الخالق سبحانه وتعالى والإطاحة بمفهوم الإيمان الديني، عصف معه المرجعية للأخلاق، وأصبح الخير والشر نسبيًّا، فالخير ما يراه المجتمع والشر ما يرفضه المجتمع، وبالتالي أصبح المجتمع وليس الخالق هو المرجعية في تحديد معيارية الأخلاق والخير والشر.
و"نسبية الأخلاق" تعني أن فكرة الخير والشر تتغير حسب المكان والزمان، هي فكرة مستمدة من الفكر الإغريقي القديم القائل "الإنسان مقياس كلّ شيء"، وبذلك تأسست نسبية الأخلاق في الحداثة مع تأكيد "ميكيافيللي" لشعار "الغاية تبرر الوسيلة"، فعاد بالأخلاق إلى النزعة النسبية، كذلك فُسرت شهوات الإنسان برغبته في حفظ الحياة، فاقترن الخير باللذة، والشر بالألم. وهذا الاتجاه فتح أبوابًا من الشرور وأصبح الإنسان وكأنه إلـــــه نفسه، لذلك أخذت تظهر تشريعات غريبة مثل إباحة الشذوذ والزنا والخمر.
فكرة العنصرية: ظهر الاستعلاء الحضاري مع ظهور الذهنية الإقصائية، والذي يستمد روافده من التنظير الفلسفي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والذي لا يرى حضارة إلا الحضارة الغربية، وهي رؤية سعى لترسيخها فلاسفة غربيون، استنادًا إلى "نظريات" متعددة، منها التفسير العنصري، في "عبء الرجل الأبيض"، والادعاء بأن هناك تراتبية بين الجنس البشري، أشبه بالتراتبية بين الكائنات، فوُضع الجنس الأبيض في المرتبة الأولى لاستجماعه المواهب والقدرات، ليأتي الزنوج والهنود في ذيل البشرية باعتبارهم عاجزين عن التعلم والتحضر، كانت تلك الذهنية وراء الجحيم الذي أصاب الشعوب التي تعرضت للهجمة الاستعمارية الغربية في تلك الفترة؛ إذ بررت الظاهرة الاستعمارية، والممارسات الوحشية التي ارتكبها الغرب في المستعمرات.
العلمنة: من أهم تجليات الحداثة، وكانت عبارة عن الفصل الحاد بين الدين والمجال العام، وسعت لتكون أيديولوجيا بديلة للدين، بل سعت إلى أن تكون "مقدسة"، وتم محاربة مفهوم الفطرة، وكأنه أسطورة، فرفض المفكر الإنجيلزي "جون لوك" الفطرة وقال: "العقل مجرّد صفحة بيضاء تمامًا والتجربة هي التي تخطّ عليه سطورها".