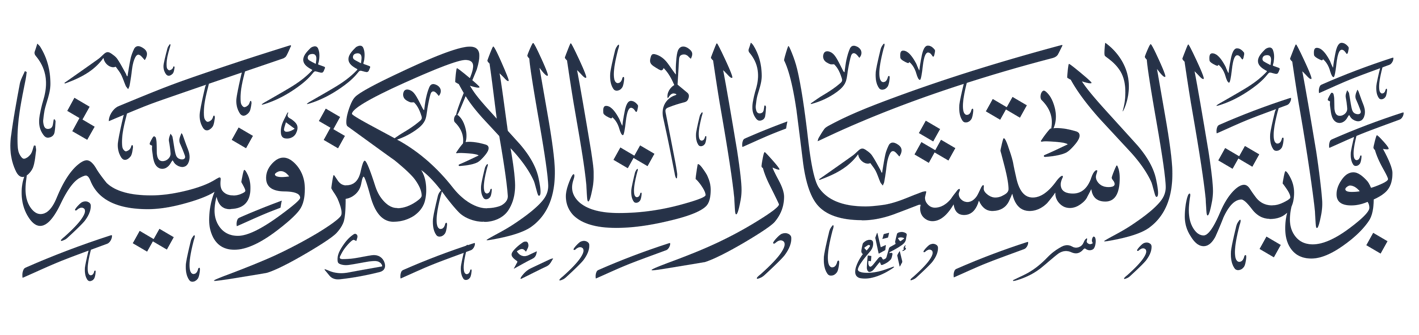الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 81
81 - رقم الاستشارة : 1737
24/04/2025
 81
81
السلام عليكم، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للكتاب؟ وهل حظي الكتاب في الحضارة الإسلامية باحترام وتقدير؟
حددت الأمم المتحدة، من خلال منظمة اليونسكو أو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" يوم (23 أبريل) من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للكتاب؛ نظرًا لأن هذا اليوم يصادف وفاة عدد من المفكرين والأدباء مثل "وليم شكسبير".
ولعل هذا اليوم يعيد تذكيرنا بعطاء الحضارة الإسلامية في مجال الكتب والمكتبات، وكان من أبرز ما قدمته هو الوقف على الكتب والمكتبات، وهو وقف عرفته أغلب الأقاليم الإسلامية، وكذلك ظهر في الكثير من الفترات التاريخية.
والـــوقف، هو "الحبس عن التصرف، أي حبسته أو تصدقت به، أو أبدته أي جعلته في سبيل الله إلى الأبد". ومن الناحية الشرعية يُعرف الوقف بأنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه". وكان صاحب أول وقف في الإسلام هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ونشير هناك إلى مثال، وهو الوقف على الكتب في الأندلس، حيث عرفت الأندلس اهتمامًا كبيرًا بصناعة الكتاب من كافة جوانبه، من تأليف وعناية وإنشاء مكتبات، واستجلاب للكتب من الخارج خاصة من بغداد والشام ومصر.
وقد عُرف عن الأندلسيين النهم في شراء واقتناء الكتب، والنهم في القراءة، وكانت المساجد الكبيرة، غالبًا، ما تكون محل الوقف للكتب والمكتبات.
وقد عرف عصر الخليفة الحكم المستنصر بالله (ت:366هـ=976م) قمة الازدهار في هذا المضمار، تذكر المصادر التاريخية أن "الحكم المستنصر كانوا يلقبونه بعاشق الكتب، وهو الذي أنشأ المكتبة الأموية، وكان يشتري الكتب مهما بالغ الناس في أثمانها، بل إنه أحضر النسخة الأولى من كتاب الأغاني قبل أن يطلع عليه أهل بغداد أنفسهم، وكان يحيط نفسه بالنساخ والماهرين في فن التجليد، وكانت له خزائن ضخمة من الكتب.
وكان يبذل الأموال لمن يؤلف الكتب، بل كان يعفي من يؤلف الكتب من الجهاد والالتحاق بالجيش، وقد فعل ذلك مع الفقيه عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار، سنة 352هـ في إحدى الغزوات للروم، حيث طلب مقابل الإعفاء أن يؤلف له كتابًا في أشعار خلفاء بني أمية في الشرق والأندلس، على غرار كتاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس".
ويؤكد المستشرق الشهير "دوزي" أن "أغلب الناس في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أصبحوا قادرين على القراءة والكتابة".
ويصف العلامة ابن حزم (المتوفى 456هـ) ضخامة المكتبة الأموية، بحديثه الذي أجراه مع القائم بأعمالها في عهد الحكم المستنصر ويُدعى "تليد الفتى" قال ابن حزم: "وأخبرني تليد الفتى -وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس- أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، في كل فهرسة خمسون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط"، أي أن عدد فهارس المكتبة الأموية كان 2200 ورقة فيها أسماء المؤلفات فقط، وهذا دليل على ضخامة تلك المكتبة الملكية التي يمكن تقدير عدد الكتب بها بأكثر من 100 ألف كتاب.
ذكرت بعض المصادر أنه كان في الأندلس سبعون مكتبة عامة منها عشرون في قرطبة وحدها، وتذكر المستشرقة "زينغريد هونكه" أن حكام الأندلس أقاموا في كل حي دارًا للكتب وزودوها بالكتب، وكانت في متناول العامة، وكان الإنفاق على المكتبات بصفة عامة من ريع الأوقاف التي توقف عليها؛ حيث كانت الدولة تخصص لها أوقافًا معينة، ويقدم لها بعض الأغنياء وأهل الخير أوقافًا تساعد في الإنفاق عليها.
ومن تلك الأمثلة، مكتبة مسجد مالقة بالأندلس، وقد تلقت الدعم من العلماء بما يحبسونه عليها من كتب، ومنهم محمد بن لب الكناني، الذي وقف عليها جزءًا كبيرًا من مكتبته الخاصة، وتقول الرواية التاريخية إن "ابن لب قبل وفاته حبس داره وطائفة من كتبه على الجامع الكبير ومكتبته"، كما وقف الفيلسوف "أبو الوليد الباجي" (ت 474 / 1081 م) كل كتبه.
وقد ساهم الوقف على الكتب في تنشيط حركة التأليف في الأندلس؛ حيث تفرغ عدد كبير من العلماء في مختلف المجالات للتأليف، نتيجة توفر المكتبات الوقفية ووجود عدد لا بأس به في كل مدينة أندلسية، كما كانت تلك المكتبات تفتح أبواب المعرفة أمام الجميع.
وقد أجاز عدد من فقهاء الإسلام الوقف على الكتب، قياسًا على الوقف على المصاحف، يقول الفقيه الحنفي "نصير بن يحيى" (ت: 268هــ): "يجري على الكتب ما يجري على المصاحف؛ لأنها تدعو إلى الدين، وتساعد على فهمه"، ثم تتابعت أقوال الفقهاء في تجويز الوقف على الكتب.
وقد أوقف بعض العلماء كتبهم لصالح طلبة العلم، مثل العلامة "ابن خلدون" الذي أوقف تاريخه على خزانة جامع القرويين بمدينة فاس، ومما جاء في تلك الوقفية أن الكتاب "لا يمكث عند مستعيره أكثر من شهرين وهي المدة التي تتسع لنسخ الكتاب المستعار أو مطالعته ثم يعاد إلى موضعه".