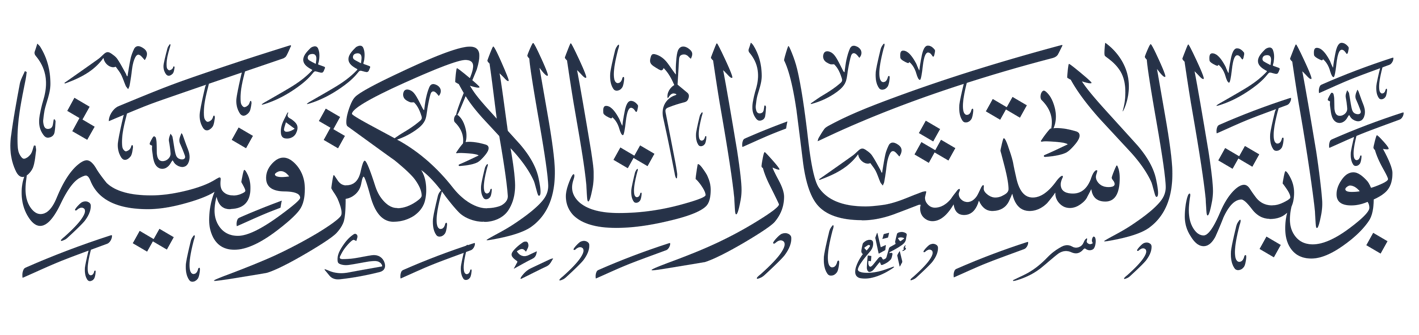الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 435
435 - رقم الاستشارة : 1598
14/04/2025
 435
435
أسمع كثيرًا كلمة المفهوم، فماذا نقصد بالمفهوم هذا الكلمة الحاضرة في كل الخطب والمقالات والأخبار والأبحاث؟
في سعي الإنسان لفهم ما حوله من أشياء ومدركات، وحاجته إلى التعامل مع الخبرات والمواقف المختلفة، لجأ الإنسان إلى عقد مقارنات بين الأشياء أو تقييمها أو تصنيفها، وهذه العملية فرضت أن يقوم الإنسان بتجريد الأشياء (والتجريد هو عملية التفكير التي من خلالها تبتعد الأفكار عن الأشياء)، وكذلك لجأ إلى التعميم (والتعميم: هو عمليَّة جمع خصائص مشتركة بين موضوعات داخل مفهوم واحد، وسحبها على فئات لا متناهية من الموضوعات الممكنة المشابهة لها)؛ لذا ظهرت المفاهيم، كمحاولة من العقل لاستيعاب الأشياء وتصورها وإدراكها.
والمفهوم من الكلمات الحديثة في التداول، خاصة في المجال البحثي والمعرفي والعلمي، ويؤرخ البعض بداية استعمالها في اللغة الإنجليزية إلى القرن الخامس عشر الميلادي.
والكلمة لها معان متعددة ومتداخلة، فهي تعني الفكرة المجردة عن الخصائص التي تعبر عن الشيء الذي تتحدث عنه وتتناوله، وهي تعني التصور الذهني عن الشيء، والانطباع والصورة الذهنية الموجود في العقل عن ذلك الشيء.
وأما في قاموس اللغة العربية فله ثلاثة معان أساسية هي: المعرفة والعقل والعلم، فيُقال فهمت الشيء أي عرَفتُه وعقَلتُه وعلمته.
وقد عرفه "أبو البقاء الكفوي" (المتوفى 1094هـ)، وهو من علماء المذهب الحنفي وقضاته، ومن علماء اللغة العربية، بالقول: "هو الصورة الذهنية، سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا".
أما العالم الهندي "محمد علي التهانوي" في كتابه النفيس "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" فعرفه بالقول إن "المفهوم عند المنطقيين: ما حصل في العقل".
ومن ثم فالمفهوم هو مجموعة من الصفات والخصائص التي تُحدد الموضوعات التي ينطبق عليها اللفظ تحديدًا يكفي لتمييزها عن الموضوعات الأخرى، وهو يتألف من المعاني والمشاعر التي يستدعيها اللفظ في أذهان الناس.
وحتى تصير الفكرة مفهومًا ينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط، منها: أن تتمتع بالعمومية والدقة معًا، وأن يُساعد في عملية المعرفة؛ إذ أن المعرفة العلمية لا قوام لها بدون المفهوم، فهو أداتها، وليس مجرد حصيلة لها، ومن ثم فهو أشبه بالوعاء المعرفي الجامع.
وأهمية المفاهيم أنها أسس وعصب الفِكر، وتساعد في التأصيل المنهجي للقضايا؛ فالمفهوم هو الخطوة الأولى في بناء العلوم المختلفة خاصة العلوم الاجتماعية، ومن دون مفاهيم واضحة لن يكون هناك وصف صحيح، ولا تحليل يمكن الاعتماد عليه للتوصل لتفسيرات أو تنبؤات، كما أن المفهوم هو الفضاء المعرفي لأية حضارة، يحدد سماتها التي تعطي لها ملامحها الذاتية، وتتكاثف فيه أبعادها الأساسية من العقيدة واللغة والمنهج.
ظل مصطلح المفهوم في التراث العربي والإسلامي منحصرًا ضمن مباحث اللغويات والمنطق، وعرفت الخبرة الإسلامية الدمج بين علم الفقه والمنطق اصطلاحًا واستعمالاً، لكن المفاهيم الكبرى، كالثقافة والعلم والمعرفة والدين ظلت حديثة نسبيًّا.
وفي عالم المفاهيم لا يمكن قصر التعريف على اللغة والاصطلاح فقط، ولكن لا بد من ربط المفهوم بالبيئة التي أنتجته وظهر فيها، ويلاحظ أن المعجم الحداثي يعتبر بالإنسان وليس بالإله، وبالعقل وليس بالغيب، وبالحياة الدنيا وليس بالآخرة، وهو ما يجعل دلالة المفهوم واستخدامه مختلفًا داخل حيز الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية.
يلاحظ أن المفهوم تحمله الكلمة رغم أنها في بعض الأحيان ليست أمينة عليه؛ لأن تكرارها يعني تكرار المفهوم ذاته؛ لذا فالمفهوم يصنعه السياق الذي يتشكل فيه.
والحقيقة أن المفاهيم ليست إجراءات محايدة، ولكنها متحيزة مرتبطة بالنموذج المعرفي، والثابت أن المفاهيم عرفت الهجرة من ثقافة إلى أخرى، ومن ميدان معرفي إلى آخر، وتوقف المفاهيم عن الهجرة يصيبها بحالة اختناق وانغلاق، والثابت -أيضًا- أن الإنسان فهم الكون والحياة والإنسان ونمط العلاقات انطلاقا من مجموعة من المفاهيم والمعتقدات والتصورات.
فمثلاً مفاهيم الثقافة والحضارة والاتصال والإعلام من المفاهيم المهاجرة، انتقلت من مواطن نشأتها في الغرب إلى أماكن توطن متنوعة، ومنها البيئة العربية والإسلامية، ورغم ذلك ظلت تلك المفاهيم أسيرة للرؤية الغربية، رغم القشور والمسوح التي غطتها من الثقافات المختلفة، فظلت تستبطن الخصوصية الغربية التي أنتجتها وأشاعتها، وهي تختلف عن الخصوصية الحضارية الإسلامية ذات الطابع التوحيدي والاستخلافي المرتكزة على قيمة الإنسان ووظيفته الحضارية.