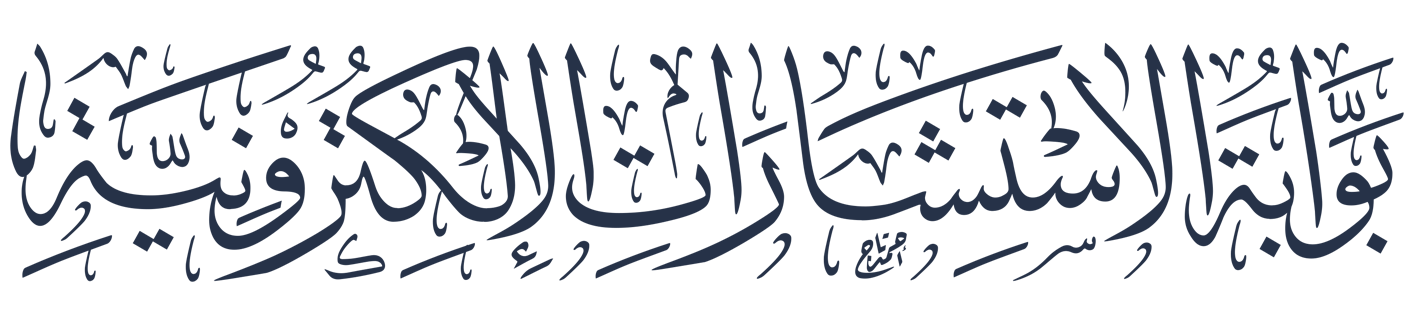الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : قضايا إنسانية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 50
50 - رقم الاستشارة : 2893
06/10/2025
 50
50
ظاهرة زيادة الملل في حياتنا هل لها أبعاد فكرية وفلسفية تتعلق برؤيتنا للذات والكون أم بالتطورات الحديثة؟
أخي الكريم، الملل الذي تعاني منه لا يقتصر عليك وحدك، ولكنه أزمة الحياة الحديثة؛ إذ أصبح من المفردات التي زاد انتشارها في القرون الأخيرة، وكان أشد أنواعه هو الملل الوجودي، الذي يشعر فيه الإنسان بغياب المعنى، وتلاشي الجانب المتسامي في تكوينه أمام إلحاح الاحتياجات والشهوات والملذات.
الملل والحداثة
حسب معاجم إنجليزية فإن أول رصد للكلمة في المجال التداولي جاء بعد العام 1750م وتحديدًا عام 1767م حيث أخذت الكلمة في الاستخدام، وهذه البداية لاستخدام كلمة الملل لها دلالتها، فقد جاءت مع حركة التنوير الأوروبية، التي ركزت على استخدام العقل والاعتماد على المنهج العلمي التجريبي، فكان العقل هو وسيلة فهم العالم، وأصبح التشكيك في الدين من أسس ذلك العصر.
تؤكد دراسات غربية أن الملل ارتبط بالحداثة، التي تعتمد العقل وتنحي كل ما هو غيبي في تحصيل المعرفة، فالحداثة ركّزت على الفردية والاستهلاك، وهذا أدى إلى نوع من الملل؛ لأن تسارع الحياة وتغييب الهياكل التقليدية خاصة الدينية، ثم الاستغراق في التكنولوجيا والمعلوماتية، كل ذلك أدى إلى فراغ روحي يحتاج إلى ملء بقيم ذات معنى وهو ما لم تستطع قيم الحداثة والرأسمالية من تحقيقه، ولكنها طرحت بديلاً آخر وهو النهم الاستهلاكي والتمادي في السعي وراء اللذة.
بعض الفلاسفة مثل الأمريكي "هنري ديفيد ثورو" (ت: 1862م) حاول أن يؤكد أن الملل فطرة ملازمة للإنسان منذ خُلق آدم أبو البشر، ومن ثم فهو ينحدر مع الطبيعة البشرية منذ نشأتها الأولى، وأن الملل ليس وليد ظروف تاريخية وسياقات ثقافية واجتماعية، لكن رؤية "ثورو" لم تؤيدها آراء الكثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع الآخرين الذين رأوا أن الملل ما هو إلا وليد لظروف اجتماعية وثقافية، وأن تلك السياقات ترتبط بالحداثة وما تلاها من تطورات وتسارع تكنولوجي ومعلوماتي أدى إلى إحداث تغيرات كبرى في الحياة والعقل الإنساني.
الملل جذر كل شر
اعتبر الفيلسوف واللاهوتي الدنماركي "سورين كيركيجارد" (ت: 1855م) أن "الملل هو جذر كل شر؛ لأنه الرفض اليائس لأن تكون على طبيعتك".
وقد جرى استخدام مفهوم الملل، في كتابات مسيحية قديمة للنساك والرهبان، وكانوا يسمونه "شيطان الظهيرة"، فعندما يصل التنسك والتعبد لهؤلاء إلى مرحلة تسمى "الفتور" والملل العبادي، فإنه يشعر أن النهار "خمسون ساعة" على حد تعبيرهم، وهو ما يحرضه على التفلت من التعبد نحو النوافذ لمشاهدة الضياء والشمس والطبيعة.
ولا شك أن ما يسمى "شيطان الظهيرة" أو الملل التعبدي، كان في حقيقته سيرًا ضد طبيعة الفطرة الإنسانية التي تحتاج إلى ترويح وراحة، وكسر لحلقات الملل، على اعتبار أن حقيقة العبادة هي استحضار الروح في توهجها أمام الرب، وليس إكراهها على الحضور الدائم، وهي الرؤية التي حرصت النصوص الإسلامية على تأكيدها، من أن تعبد المسلم في نشاطه، فإن أصابه فتور فليترك عبادة النافلة حتى يتجدد نشاطه.
الخطورة الأكبر للملل في الحياة المعاصرة، كونه عقبة كئودًا أمام تحقيق السعادة، يقول "فيكتور هوجو" في رواية البؤساء: "هناك شيء أفظع من جحيم المعاناة، جحيم الملل"، فالملل، قد يسعى لتحفيز الإنسان نحو أفعال قد تكون ضاره له وللمجتمع؛ لأن حقيقة الملل تكمن في أنه رغبات لم تتحقق، وتحتاج إلى إشباع، وتشير أبحاث في علم الاجتماع إلى أنه إذا ساد الملل في وقت الفراغ، وكان هناك نقص في القدرات والمهارات الشخصية، وضعف في فرص الترفيه، فإن هناك جريمة متوقعة أو سلوك منحرف.
روابط ذات صلة: