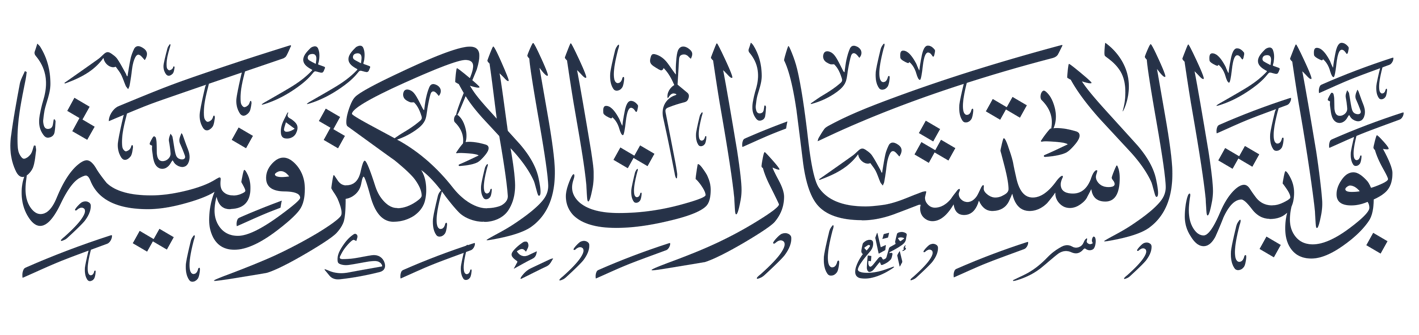الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 94
94 - رقم الاستشارة : 1702
21/04/2025
 94
94
تفسيرات العقل لبعض الحقائق في الكون تؤكد أن العقل والعلم غير قادر على تفسير الكثير من ظواهر الكون، فهل هذا القصور يثبت أن للعقل حدودا في علمه؟
يقول الإمام الشاطبي: "إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًّا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون".
يطرح البعض فرضية أن العقل والعلم قادران على تفسير نشأة الكون وبداية الخلق، ويمنحون العقل ثقة للانفراد بطرح تفسيرٍ عن تلك النشأة، وطُرحت أكثر من نظرية لتفسيرها، وكان التضارب بينها كبيرًا، كما طُرحت افتراضات عن عمر الأرض، وكان الاختلاف في تحديده كبيرًا للغاية.
ولعل الفكرة التي تقف وراء هذا الإصرار على إقحام العقل والعلم في تلك القضية التي لم يكن شاهدًا عليها، ولا مشاركًا فيها، إقامة حاجز متوهم من العلم، أمام الرؤية الدينية المفسرة لنشأة الكون، والتي تعلن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون بأمر منه، سبحانه وتعالى.
الإلحاد يسعى لمحو الرؤية الدينية المفسرة لنشأة الكون، لإنكاره وجود الخالق سبحانه، ولذا يزعم أن الكون بلا بداية، أي أن الكون أزلي وأنه أوجد نفسه، ورغم زيف تلك المقولة وتهافتها، فإن الإلحاد يضفي عليها العلمية، وهي مقولة لا تقوم على سند ولا دليل، حتى العقل البسيط يرفضها رفضًا تامًّا.
فمع مطلع القرن الماضي أخذت أبحاث ونظريات غربية ترفض أن الكون لم تكن له بداية؛ ففي العام 1931م، قال الفيزيائي وعالم الفلك البلجيكي "جورج لوميتر" إن الكون نشأ من ذرة بدائية، وكانت تلك النظرية بداية لما طُرح بعد ذلك في نظرية "الانفجار العظيم" Big Bang التي تزعم أنه "قبل حوالي 13.8 مليار سنة، بدأ الكون بأكمله من بقعة واحدة كثيفة وشديدة الحرارة، تُعرف هذه البقعة باسم "التفرد"، وهي تُمثل بداية ما نعرفه الآن بالمكان والزمان والمادة، ومع تمدد الفضاء وبرودته مع مرور الوقت، اندمجت الجسيمات دون الذرية لتشكل ذرات تطورت لاحقًا إلى مجرات ونجوم وكواكب بعيدة. وقد شكّلت هذه الذرات في النهاية نظامنا الشمسي والبنية الكونية التي نمتلكها اليوم".
وهذه النظرية تعتمد على نماذج رياضية لتفسير نشأة الكون، ولا توجد أدلة حقيقةً على إثباتها، ولذا طرحت نظريات أخرى لمعالجة الأسئلة التي لم تستطع نظرية الانفجار العظيم أن تفسرها أو تقنع العلماء بصحة مزاعمها، فطرحت تساؤلات منطقية مثل: ماذا حدث قبل الانفجار العظيم؟ وأخذ بعض العلماء في استبعاد نظرية الانفجار، لصالح نظريات أخرى تتحدث عن دورة الانفجار والارتداد في تفسير نشأة الكون.
والحقيقة أن كل ما تطرحه تلك النظريات عاجز عن تفسير نشأة الكون، أما المضمر في الإصرار على ادعاء العلمية على تلك النظريات من جانب بعض الملحدين، فهو رفضهم الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وأن الكون لم يخلق نفسه بنفسه، وإنما انصاع لأمر الله "كن فيكون".
لذلك يقول العلماء الذين ينقدون نظرية الانفجار العظيم إن "هناك قطعة مفقودة من اللغز، وهذه القطعة هي اللحظات الأولى من عمر الكون نفسه".
والواقع أن هناك حقائق لا يمكن إنكارها، ويجب أن يسلم بها عقل الإنسان؛ فعدد من العلماء المعاصرين يؤكدون أن الإنسان خُلق وفي داخله قدر ما من المعرفة المسبقة، وعلى رأس هؤلاء عالم اللغويات الشهير "نعومي تشومسكي" الذي تحدث عن مفهوم الفطرة، فيقول عن نظرية اللغة: "إن كل لغة تنشأ اليوم، لها جذر مشترك في مركز اللغة الموجود في الدماغ البشري، ويمكن أن تعزى الأشكال المختلفة التي نشأت بها اللغات إلى أنها مجرد طرق ونُهج متنوعة للربط بين الكلام وبناء الجمل، وليست تطورًا ثقافيًّا، ولكنها كانت في الأساس إعادة تشكيل لغرائز كانت موجودة بالفعل منذ الأزل".
ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لا يولد وهو صفحة بيضاء، ثم يأتي المجتمع وينقش عليها ما يريد، ولكن –الحقيقة- الإنسان يولد في أعماقه معرفة مركوزة، وحسب الرؤية القرآنية فإن الله تعالى هو من علّم آدم الأسماء كلها، وهذه المعرفة مركوزة في الفطرة الإنسانية، ثم تأتي السياقات المجتمعية وتظهرها وتصقلها وتطورها، فهي كالبذرة التي تحتاج إلى الماء لتنمو، ولا يعني حاجتها إلى الماء أنها لم تكن موجودة.
ولعلنا نقف أمام هذا الآية العظيمة من سورة الكهف رقم (51) التي تكشف زيف تلك الدعاوى، وتنبه أن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لم يشهده أحد من الناس، وأن على الإنسان الاعتراف بأن الله تعالى هو الخالق {مَّآ أَشۡهَدتُّهُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ أَنفُسِهِمۡ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلۡمُضِلِّينَ عَضُدٗا}.
ومن روائع ما ذكره الإمام القشيري في تفسير هذه الآية قوله: "إنَّ علومَهم (أي البشر) تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم وجميع أحوالهم وعن كُلِّ ما في الكون، ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ ولا حاجة بهم إلى الوقوف على ما قصرتْ علومُهم عنه، إذ لا يتعلَّق بذلك شيء من الأمور الدينية. فالإشارة في هذا أن يَصْرِفُوا عنايتَهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وبأحكامه".