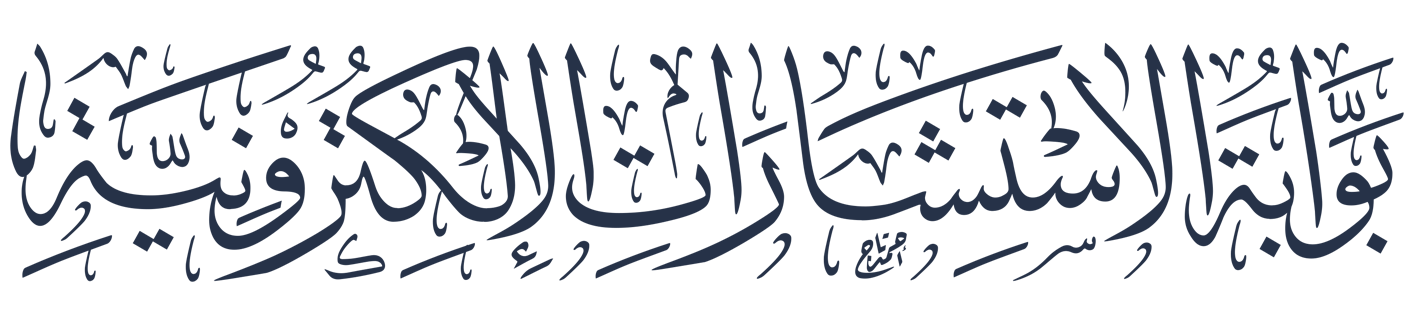الإستشارة - المستشار : د. عادل عبد الله هندي
- القسم : دعوية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 123
123 - رقم الاستشارة : 1222
08/03/2025
 123
123
أنا أحد الدعاة في بلاد الغرب، وأواجه تحديات كثيرة في توصيل الخطاب الدعوي للمسلمين وغير المسلمين هنا، خاصة مع اختلاف اللغة والثقافة، ووجود بعض الصور النمطية السلبية عن الإسلام. ما هي أهم المقومات التي ينبغي أن يقوم عليها الخطاب الدعوي في الغرب، بحيث يكون ناجحًا ومؤثرًا ومحققًا للمقاصد الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الدّعاة المُصلحين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعــــد:
فمرحبا بك أخي الداعية المبارك، واعلم أخي الكريم بأنّ الدّين يُعدّ عنصـرًا أساسيًّا وعاملاً فاعلاً في العلاقات بين الأمم والشعوب، وكذا بين الثقافات والحضارات. وقد بدا في الآونة الأخيرة زيادة عدد المسلمين في بلاد الغرب -باختلاف قاراتها ولغاتها- كما لم يعد المسلمون في أوروبا وغيرها -من الأقطار الأجنبية عن واقع العالم العربي والإسلامي- مجرد جاليات وأرقام وافدة، بل أصبح الكثير منهم جزءًا رئيسيًّا من تلك الشعوب وأرقامًا فاعلة؛ يتعايشون مع المجتمعات الغربية تعايش مواطنة، ويساهمون حضاريًّا وفكريًّا وثقافيًّا في تلك المجتمعات التي يحيوْنَ فيها.
كما أنّ الوجود الإسلامي في مثل تلك البلاد إنما هو وجود يعتريه الاستفادة بخيرات تلك البلاد من أمنها وحريتها وطعامها وشرابها، بما يستدعي أن يكون أهل الإسلام فيها أهل وفاء لها.
ومن هنا تبرز حاجة المسلمين أولًا إلى الخطاب الديني الوسطي الرشيد، الذي يرشدهم ويدعمهم روحيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، وفي نفس الوقت يحصّنهم من التطرف الفكري والانحلال الأخلاقي، وكذلك يعتبر هذا الخطاب هو قنطرة التواصل الثقافي بين المسلمين وغيرهم في هذه البلاد متعددة الثقافات والأديان.
وفي البداية يجدر بنا ضبط المصطلح من أجل أن ننتقل إلى مقوماته.
المقصود بالخطاب الديني والدعوي:
والخطاب الديني هو البيان الذي يوجه باسم الإسلام إلى الناس مسلمين وغير مسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو تعليمه لهم أو تربيتهم عليه عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وفكرًا وسلوكًا لشـرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم فرديًّا أو اجتماعيًّا روحيًّا أو ماديًّا نظرية أو عملية.
وهذا الخطاب الديني -في السياق الغربيّ- يمر بأزمة حقيقية، وتحديات كبرى، لعلَّ أبرزها، ما يأتي:
- ضعف التأهيل لدى الأئمة والدعاة الذين يقومون بعملية الخطاب الديني أو بالأحرى غياب المتخصصين المؤهلين.
- وجود فجوة بين الخطاب والمُخَاطَب، وهي فجوة اللغة، وأعني هنا لغة البلد الغريب، سواء أكانت إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو يابانية أو غير ذلك.
- عدم معايشة وإدراك الخطاب الديني للواقع الغربي -المختلف- ومشاكله، والتحديات التي يواجهها المسلم الغربي، وبالتالي لا يقدم الخطاب للمسلم الحلول الدينية والدعم الروحي للمشكلات التي يواجهها.
- محاولة الانتقال بالقناعات التي عاشها المسلم في بلده إلى تلك البلاد رغم مخالفة الواقع للواقع، ومن هنا يلزم البحث عن المقومات الأمثل لنجاح الخطاب هناك.
- فضلا عن بعض الصـراعات الدائرة بين إدارات المراكز الإسلامية وأئمتها ودعاتها؛ إمّا لأمور نفسية، أو لأبعاد عِرقيّة وقوميّة، أو لاختلافات مذهبيّة، وينتج عن ذلك مثلا: (تخوين بين بعض الدعاة وبعض مديري المراكز الإسلامية في بلاد الغرب، مع التهميش المتعمّد للداعية؛ حتى يظل المدير هو كل شيء، بينما الإمام والداعية لا شيء)، بما يترتب عليه عدم الإبداع والإنتاج الدعوي المتميّز.
وهذه بعض مقومات الخطاب الدعوي في بلاد الغرب، بيانها على النّحو التالي:
أولاً: الاهتمام بالتأهيل العلمي والشـرعي للوعّاظ والواعظات، وتعليم الجميع ألَّا تلوّن في الدعوة والخطاب الدّعويّ؛ فالدَّعوة واضحة، وخطاب الدعاة مكشوف لا خفايا فيه.
ثانيًا: إحياء وإبراز فقه المقاصد والعلل في شرح الإسلام أو التعريف به؛ فإنّ العقول دائمًا ما تحتاج إلى بيان المقاصد والأسباب؛ لتقتنع أكثر وأكثر بصلاحية الأحكام الشرعية لحياة البشر.
ثالثًا: إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقبول التعدّد والتنوع، قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118، 119].
رابعًا: إحياء ثقافة التعايش مع مكونات المجتمع غير المسلم؛ يقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
خامسًا: فهم طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ فإنّ فهم تلك الطبيعة من منظور الإسلام يدفع في نفس الداعية تحديد الأهداف والغايات المتعلقة بالدعوة فهمًا وحركةً وسلوكًا.
سادسًا: معرفة وضع الجاليات المسلمة خارج بلاد العرب والمسلمين؛ بحيث يرفع الداعية إلى الله تعالى واقع تلك الجاليات المسلمة من حيث واقع التدين، الاجتماعيات، الثقافات، الأوضاع الأخلاقية، فضلا عن استكشاف القضايا والتحديات التي تواجه المسلمين في بلاد الغرب، من تلك القضايا المعاصرة في العبادات والمعاملات.
سابعًا: تحديد مصادر الكراهية والخوف من الإسلام في الغرب وتحديد أسباب ذلك؛ ليتسنَّى وضع حلول نظرية وعملية لتلك الأسباب المؤدية إلى شيوع الكراهية بين المسلمين وغير المسلمين.
ثامنًا: وضوح وسائل تحسين صورة الإسلام في أذهان الدعاة؛ ولا يتأتَّى ذلك إلا بالدراسة والتعلّم، قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ} [يوسف: 108].
تاسعًا: التعرف على بعض التجارب الناجحة في بلاد الغرب وترميزها والاستفادة منها إما بالحديث الجماهيري عنها أو بتربية الجيل الناشئ على شيء من صفاتها وسماتها.
عاشرًا: عدم احتقار العصاة والمذنبين أو احتقار المعروف مهما صغر من المسلم وغير المسلم، والمبدأ (لا تحقرنّ من المعروف شيئًا) ولا يستبْعد الداعية هداية أحد من الناس؛ فالقلوب بيد خالقها يقلبها كيفما يشاء.
حادي عشـر: عدم نسيان فضل تلك البلدان على قاطنيها من المهاجرين المسلمين الذين هجروا بلادهم إلى تلك البلاد الغربية.
ثاني عشـر: الاهتمام بالخطاب العقلي والعاطفي على السواء؛ بحيث يعمل الخطاب الدعوي على ردّ النَّاس إلى الفطرة السوية من منطلق عقلي لا ديني فقط.
ثالث عشـر: عدم التشنج الدَّائم ضد المخالِف أو التحدث بنظرية المؤامرة أو صناعة صراع ديني أو اجتماعي أو ثقافي مع الآخر؛ فإنّ أي خطاب يكرّس العقلية التآمريّة خطاب فاشل.
رابع عشـر: استعادة النموذج الحضاري للإسلام والمسلمين عبر التاريخ، ودعوة المسلمين للعودة إليه بصورته العصـريّة؛ بما يتلاءم مع إنسان العصـر، مع عدم التفريط في الأسس والأصول الإسلامية.
خامس عشـر: عدم التحجّر على القناعات القديمة (منطقة الراحة السلوكية والفكرية)؛ وإنما ضرورة الانطلاق نحو الجديد والاستماع إلى أصوات مغايرة ورؤى مختلفة، بروح تعمل على تحقيق التعايش السلمي مع الآخر.
سادس عشـر: مراعاة التباينات الديموغرافية والجغرافية والتاريخية والثقافية، وألا نتعامل مع عقول مواطني الغرب (مسلمين وغير مسلمين) بنفس عقلية بلاد الإسلام والمسلمين. وهذا أمر يستلزم الوعي الإيجابي بالممارسات الشائعة في بلدان الغربة.
سابع عشـر: الحذر من تسويق صورة سلبية عن الإسلام وعن الدعاة وعن المنسوبين للدين في أي مجال من مجالات الحياة، ويجب على الدعاة والعاملين في المراكز الإسلامية ببلاد الغربة توجيه أنظار المسلمين أن مخالفة قوانين البلدان الغربية لساكنيها ليس أمرًا محمودًا؛ بل قد يكون إثمًا في كثير من الأحوال.
ثامن عشـر: الرِّفق واللين، والحذر من لعن البشـر المخالفين أو الدعاء عليهم أو تمني هلاكهم؛ لمجرد المخالفة، ولنتذكّر قول النبي الحبيب -صلى الله عليه وسلّم- (أليست نفسًا)، طالما هذه النفس لم تحمل سلاحًا ولم تُعِن غيرها على حمله واستخدامه، مع ضرورة استثمار نقاط الاتفاق بين الإسلام والدول الغربية، أو بين المسلمين وسلوكيات غير المسلمين في بلاد الغربة.
تاسع عشـر: التوجيه التربوي الرشيد من خلال الخطاب الدعوي لأفراد المجتمع المسلم داخل المجتمعات الغربية؛ بحيث يحتلّ انشغال أولياء الأمور بأبنائهم وبناتهم في بلاد الغربة مركزًا كبيرًا من واقع أشغالهم وانشغالاتهم.
العشـرون: عدم لعن البلاد الأصلية التي جاء منها المهاجرون المسلمون؛ فتلك ليست مروءة ولا وفاء ولا وسيلة لكسب القلوب الإنسانية الوطنية الأخرى.
الحادي والعشـرون: تنمية وعي الأُمم الغربية بحاجة الإنسان -أي إنسان- إلى الهدايات الربانية، الداعية إلى مراعاة الفطرة وهداياتها كذلك.
الثاني والعشـرون: الردّ المتسلسل المنضبِط على الشبهات المثارة ضد الإسلام، مع عدم التصادم مع المجتمع، والحذر كل الحذر من الحماسة الزائدة المتهورة المُندفِعَة.
الثالث والعشـرون: الخروج من دائرة التوصيف والتصنيف المتكرر للمجتمعات الغربية بالكُفر؛ ففرق بين الإيمان القلبي بصحة القرآن الحاكم بكُفر من عاند الله وأنكر وجوده ووحدانيّته وعظمته، وبين التعاملات السلوكية والاستفادة من تلك البلدان في المطاعم والمشارب والملابس والحريات والتعليم والكفالات؛ فإنك لتجد بعضهم يستمتع بما عليه الغرب، ثم يُردِّد في كل محفل، ويعمل على التسويق المقصود بأنها (أمم كافرة)، وإن كانت كذلك، فليس من الحكمة لا دينيًّا ولا عقليًّا ولا عُرفيًّا ولا إنسانيًّا أن يُكثر الدعاة من تلك النبرات وتسويقها المستمرّ عبر المنابر الدعويّة المختلفة (خصوصًا في بلاد الغرب)، ومولانا الكريم يقول لنبيه موسى وأخيه -عليهما السلام-: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44].
الرابع والعشـرون: الدَّعوة إلى الاندماج في المجتمعات الغربية مع التأكيد على عدم الذّوبان، وفرق بينهما لمن يقرأ ويبحث ويستفيد من التجربة الإسلامية من لدن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) إلى يوم الناس هذا.
الخامس والعشـرون: عدم توجيه الخطاب الدعوي في بلاد الغرب نحو الأحاديث السياسية والأوضاع العسكرية في بلدان الغرب أو غيرها، والالتزام بالخطاب الديني المستقل؛ فالأصل أن الداعية يقود ولا يُقاد، ويجمع ولا يُفرّق، ويبني ولا يهدم، وينشغل بالمصالح العامة على الحساب الذاتي.
السادس والعشـرون: ضرورة العمل على تكوين جماعات الطنين، كما يقول أ.د/ رؤوف شلبي -رحمه الله-، ومقصوده أن ينصبّ الاهتمام لدى أرباب الخطاب الدعوي في بلاد الغرب على تكوين دعاة ممن أسلموا من الغربيين أنفسهم؛ فهم أقدر على فهم طبيعة الخطاب المناسب للمجتمعات الغربية نظرًا لوعيهم اللغوي ومخزونهم التاريخي والاجتماعي والثقافي.
السابع والعشـرون: مراعاة الخطاب الدعوي في بلاد الغرب للحاضر مع استشراف المستقبل بصورة يتحقق معها غايات ومقاصد الدعوة الإسلامية.
الثامن والعشـرون: القدرة على الجمع بين (فهم النص، وفهم الواقع، فضلا عن إنزال النص المناسب على الواقع المناسب)، وتلك أبسط قواعد الوعي الصحيح بطبيعة هذا الدين ومناسبته للجماهير في كل مكان.
التاسع والعشـرون: البُعد كل البُعد عن تجريح البلدان والهيئات والأشخاص، وهذا أمر يقتضـي التركيز على مناقشة الأفكار وعدم اتهام النوايا للآخرين من مسلمين وغير مسلمين، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
الثلاثون: الموازنة في الخطاب الدعوي بين الترغيب والترهيب مع التيسير والتبشير؛ وتلك وصية النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعريّ: (يسّرا ولا تُعسّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوَعَا ولا تختلفا).
ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلماء الأمة الإسلامية حيث كانوا، وأن يرزقنا جميعًا حُسن الوعي عنه وشرف الدعوة إليه والدلالة عليه.