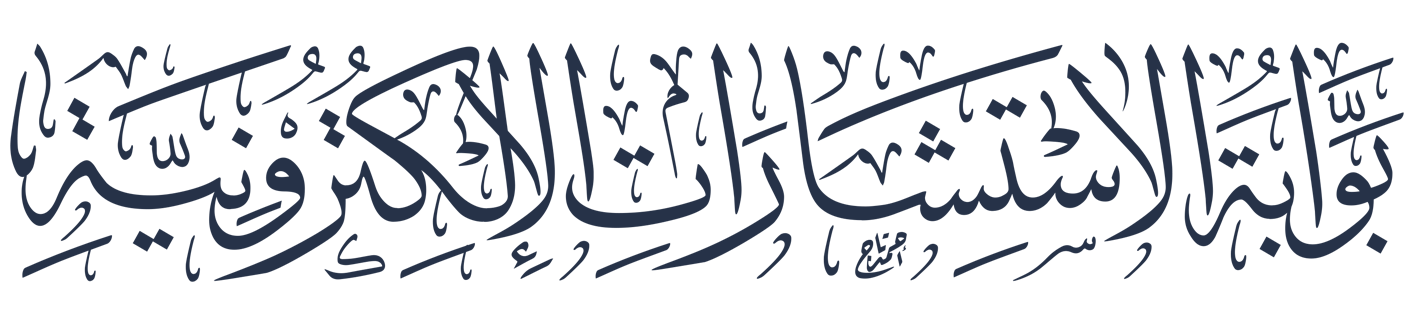الإستشارة - المستشار : أ. مصطفى عاشور
- القسم : فكرية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
 338
338 - رقم الاستشارة : 1789
29/04/2025
 338
338
يتردد كثيرا مصطلح الإنسانية أو الإنسانوية هل هذه الكلمة الجذابة تخفي خلفها أشياء أخرى؟
الإنسانوية أو الإنسانية أو الهيومانية من المصطلحات والمفاهيم، التي باتت تطرق الآذان في العقود الأخيرة، ويوحي لفظها بدلالات إيجابية، وأنه يستبطن الرحمة والتعاطف والقيم الأخلاقية.
لكن هذا المفهوم الجديد يحتاج إلى اقتراب أكثر واستكشاف أكثر وعيًا للوقوف على حقيقته وغايته وتاريخ نشأته.
الإنسانوية من المفاهيم الحديثة التي بدأ استخدامها في القرن الثامن عشر مع حركة التنوير الأوروبية، وتعرض هذا المفهوم للتغير عبر رحلة نشأته في العقود التالية، وتبعًا لذلك تنوعت تعريفاته.
وقد سبق ظهور واستخدم مصطلح الإنسانوية، ظهور اتجاهات سعت لربط الإنسانوية بالدين في عصر النهضة الأوروبية خاصة في المدرسة الإنجليزية، فنجد الفيلسوف "توماس مور" (ت: 1535م) دعا للتوفيق بين المسيحية وتلك الإنسانوية المستلهمة من فلسفة الإغريق واليونان.
لــــكن مع القرن السادس عشر بدأت الإنسانوية ترتحل بعيدًا عن أفكار المصلحين الدينيين، خاصة مع الاتجاه الفرنسي لاستلهام القانون اليوناني والإغريقي القديم ضمن التشريعات الفرنسية، وجاء ذلك في ظل تنامي النزعة العلمانية، والموقف المعادي للدين، ومساعي التفلت من هيمنة الكنيسة.
لــكن المفهوم تغير استخدامه مرة أخرى، ليعبر في استخدامه الحديث عن كونه مدرسة فكرية تهتم بالإنسان، وتجعله معيارًا لأفكارها؛ لذا تم استيعاب الإنسانوية في تلك الفترة داخل الرؤية العلمانية.
وفي تلك البواكير طُرحت فكرة مركزية الإنسان، وظهرت اتجاهات فلسفية وفكرية تُغالي في تقديس العقل، وتجعله مقياسًا ومعيارًا خاصة الفيلسوف "ديكارت" الذي طرح الشك كمعيار للوجود، مطلِقًا مقولته الشهيرة "أنا أشك إذن أنا موجود".
كان أمل الإنسانيين في عصر النهضة هو تحقيق التطور الأمثل للقدرات البشرية من خلال الجمع بين المعرفة والفضيلة، دون المرور من باب السماء أو الإيمان، وكانت بداياته من خلال التعليم، وكان أول مرة يُستخدم فيها المصطلح على يد الألماني "فريدريش إيمانويل نيثامر" عام 1808م في كتابه "النزاع بين العمل الخيري والإنسانوية في نظرية التعليم في عصرنا".
وفي عام 1859م، نشر المؤرخ الألماني "جورج فويجت" كتابه "إحياء العصور القديمة الكلاسيكية أو القرن الأول للإنسانية"، والذي ساهم بشكل كبير في إرساء الاستخدام التاريخي المحدد للمصطلح.
ومع القرن التاسع عشر الميلادي، وتحول الإنسان إلى موضوع للكثير من الاهتمامات البحثية والمعرفية، استلهمت الإنسانوية الروح المعادية للدين من العلمانية والإلحادية، التي اعتبرت أن الإنسان هو غاية في حد ذاته، وأعلنت الإنسانوية بوضوح أنه "إذا أراد الإنسان أن يتطوّر، تعيّن عليه التخلي عن الأديان الإلهية التي تحُول دون التطوّر، وإذا أراد أن يختار لنفسه دينًا، وجب أن يكون واضع ذلك الدين هو الإنسان".
وحقيقة الإنسانوية أنها تفصل الإنسان عن السماء والكون، ولا تُعنى بالأسئلة الوجودية الكبرى مثل الغاية من الوجود، وسؤال المصير، ومن ثم فالإنسانوية فلسفة أرضية تربط الإنسان بالأرض وجودًا وغاية ونهاية، ويمكن النظر إليها كإحدى محاولات تخفيف حدة الطرح العلماني والإلحادي، دون التخلي عن نزعتها المجافية للروح والغيب.
يشير كتاب "الهيومانية: دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذور" لمؤلفه "محمد هادي" إلى أن الإنسانوية المعاصرة لا هي دينية كثيرًا، ولا هي إلحادية كثيرًا، وإنما هي مفرطة في العلمانية، وأن الفصل بين الإنسانوية والعلمانية في الثقافة الغربية يكاد يكون مستحيلا، فهو في غاية التعقيد، حيث تم إرساء الإنسانوية والعلمانية في وقت متزامن، كما أن الإنسانوية العلمانية حددت هدفها بوضوح، وهو تحقيق السعادة الدنيوية، أو تشييد الفردوس الأرضي، وتلك نقطة افتراق بين العلمانية والأديان.